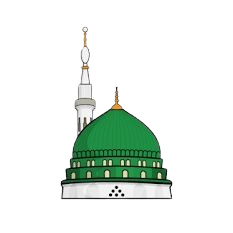﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ [البقرة:31-30-]
أول صفات الخليفة العلم والتعلم والتعليم
فما بدأت آيات الخلافة إلا بإعلانٍ ربانيٍّ عن الاصطفاء، وما أعقبه إلا ببيان التعليم، لتُعلِمَنا سُنَّةَ الله في خلفائه: أن مفتاح الخلافة العلم، وأن تاج الخليفة الأول كان المعرفة.
وجه الدلالة:
إن تقديم ذكر التعليم بعد إعلان الخلافة مباشرةً يدلُّ على أن الخلافة الإلهية لا تُنال بقوةٍ ولا جاه، بل بعلمٍ يُفيضه الله على قلب من اصطفاه، وأن العالِم الرباني أقرب إلى مقام الخلافة من العابد الذي لم يتزود بنور العلم، فالعلم نورٌ يُبصر به العبد مرادَ ربِّه.
وقد بيَّن ذلك النبي ﷺ في قوله:
“من يُرِدِ اللهُ به خيرًا يُفقِّهْهُ في الدين” [البخاري ومسلم]،
فكلُّ من أراد الله به خَيرًا، بدأ بتعليمه، وهذا شأن الخلافة: أن يكون الخليفة مرآةً لمراد الله في خلقه، ولا يكون ذلك إلا بالعلم.
2- العلم بالله يؤدي الى التحقق بمقام العبودية: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات:56]
فالغايةُ من الخَلْق ليست المُلك ولا التصرّف، بل العبوديّة، وكلّ من رام الخلافة دون أن يتحقّق بهذا المقام الجليل، فقد جهل مراد الله من استخلافه لعباده.
لكن العبوديّة عند أهل المعرفة بالله لا تكون إلا على قدمِ العلم، لا العلم المتفرّق في الأذهان، بل العلم الذي يثمرُ الخشية، ويورثُ التذلُّل لله، كما قال تعالى:﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ [فاطر: 28]
فمن عرف الله، عظَّم أمره، وأدرك أنّ الخلافة لا تعني التسلُّط على الخلق، بل تعني القيام بحقوق الحقّ في الخلق، وهذا لا يكون إلا لعبدٍ خالصٍ، قام بالله، لا بنفسه، وكان في الأرض مظهرًا لحكم الله، كما كان آدم عليه السلام.
وجه الربط:
إنّ آدمَ عليه السلام لم يُؤهَّل للخلافة لأنه أوّلُ الخلق فقط، بل لأنه عُلِّم، فعبَد، فخضع، فاستُخلِف، فدلّ ذلك على أنّ كلّ خليفة في الأرض لا يكون خليفةً بحقٍّ إلا إن كان عبدًا لله بحقّ.
من أهم معالم الخلافة، كما جاء في الحديث القدسي، ما رواه البخاري في صحيحه، قال الله تعالى: “من عادى لي وليًا فقد آذنته بالحرب، وما تقرّب إليّ عبدي بشيء أحبّ إليّ مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبّه.” [رواه البخاري]، فهنا نجد أن المفتاح الأساسي لتحقيق الخلافة الحقّة هو العبودية الصادقة، والتقرب إلى الله بما فرضه أولاً، ثم بالقيام بالنوافل حتى يحب الله عبده، ويصل العبد إلى مقام الخلافة الحقيقية عندما يتزود بهذه العلاقة المميزة مع الله.
والعلاقة بين العبادة والخلافة واضحة، فكما أن الخلافة لا تتحقق إلا بالعلم، فإنها أيضاً لا تقوم إلا بالعبودية التامة، وكون الخليفة في الأرض هو الذي يؤدي الفرائض بإتقان، ولا يفرّط في النوافل التي تقرّب به إلى الله، بل يلتزم بما افترضه الله عليه ويزيد بالنوافل التي هي مظهر لتأكيد صدق عبوديته لله.
وهذا قيام الخليفة بحق المستخلف، ومن ثم هناك واجبات يقوم بها الخليفة بحق من استخلف عليه، وهم الخلق
3- من مقتضيات التحقق بالعبودية والخلافة أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [آل عمران: 110]
وقال الحبيب في الحديث الذي يرويه الإمام مسلم: “مَن رَأَى مِنكُم مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بيَدِهِ، فإنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسانِهِ، فإنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وذلكَ أضْعَفُ الإيمانِ.”
فبيَّن سبحانه أنَّ خيرية هذه الأمة إنما كانت بقيامها بوظيفة الخلافة الإيمانية في الأرض، وهي أن تكون لسانَ الحق، ويدَ الرحمة، وعينَ النصح، فتأمر بالمعروف – وهو ما وافق مرضاة الله – وتنهى عن المنكر – وهو ما يُعكِّر صفو العبوديّة – وتُقيم بذلك موازين الحق في الخلق.
وجه الدلالة:
أنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليسا مجرّد فعلَيْن عابرَيْن، بل هما وظيفة الخليفة في الأرض، لأن الله استخلف آدم وذريّته لإقامة دينه في الأرض، ولن يُقام هذا الدين إلا بهذه الشعيرة العظيمة، التي بها تُصان الأمة، وتُحيى القلوب، وتُدفع البلايا.
وقد أشار الحبيب ﷺ إلى ذلك في الحديث الذي رواه مسلم، فقال:
“مَن رَأى مِنكُم مُنكَرًا فليُغيِّرْهُ بِيَدِهِ، فإن لَم يستطِعْ فبِلِسانِه، فإنْ لَمْ يستطِعْ فبقلبِه، وذلكَ أضعفُ الإيمان.”
وجه الارتباط بالخلافة:
أنّ هذا الحديث يُرتِّب مراتبَ التصرُّف في الخَلْق بحسب القدرة، ولا يُقدِم على التغيير باليد إلا من تحقّق له مقام التمكين، وهو من مقامات الخلافة، فإن عُدِم ذلك، تكلّم بالحق، وهو من علامات العالِم المأمور بالتبيين، فإن عُدِم، فبقلبه وهو حضور العبد بمقام الإنكار وإن عُدِم التمكين، دلالةً على حياة قلبه وصدق عبوديّته.
فمن لم يأمر بالمعروف ولم ينهَ عن المنكر، فقد فرَّط في أحد أعظم شروط الخلافة، وإن لبس لبوسها، أو تزيّا بزيّها.
4- قال تعالى: ﴿يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ﴾ [ص: 26] . فمن واجبات الخليفة أن يقيم العدل وينشره بين الناس، وأن يتحقق بالعدل مع جميع المخلوقات انسها وجنا ، حيواناتها ونباتها
وهو قطبُ رحى الخلافة، وسِرّ نزول الكتب وإرسال الرسل أن الله سبحانه افتتح الخطاب بصفة الخلافة، وأتبَعها مباشرةً بأمرِ العدل، فدلَّ ذلك على أن إقامة العدل ليست وظيفةً جانبية، بل هي روحُ الخلافة، ومعيار صدقها، بل قرن الله العدالة بالاتباع للسبيل، وجعل ضدَّها ضلالًا عن سبيل الله.
والعدلُ عند العارفين بالله تعالى لا ينحصر في محاكم الناس، بل يشمل القلب، والبيت، والمجتمع، بل وسائر المخلوقات، لأن الخليفة ليس مستخلفًا على الإنسان فقط، بل على الأرض وما فيها، قال تعالى:
﴿هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾ [هود: 61]، أي طلب منكم إعمارها بالعدل والرحمة.
فالخليفة يَعدل مع الجنّ والإنس، مع الإنسان والحيوان، مع النبات والجماد، لأن نور العدل في قلبه أصلٌ لا يتجزّأ، ومن ظلم شيئًا من خلق الله، فقد خان الأمانة.
5- قال في حق الخليفة الأكمل: ﴿ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [التوبة: 128] هذه الآية الكريمة من أعظم ما نزل في بيان صفات الخليفة الأكمل، والعبد الأعظم، سيدنا محمد ﷺ، الذي جعله الله خاتم النبيين، وإمام العارفين، وقدوة السالكين، فبيَّن سبحانه أنه رؤوف رحيم، لا بالمؤمنين فقط، بل جعله رحمةً مهداة لكل الخلائق
وجه الدلالة:
أن الله لم يكتفِ في وصف نبيّه ﷺ – وهو الخليفة الأكمل – بكونه ذا رأفة ورحمة، بل قدَّم ذلك على سائر صفاته في مخاطبة الأمة، فدلّ على أنَّ الرحمة ليست سلوكًا زائدًا، بل هي من مقتضى مقام الخلافة الحقيقي، فحيثما حلَّ خليفة الله في أرضه، نزلت السكينة، واطمأنّت القلوب، ووجدت الخلائق ظلًّا من فيضِ الرحمة التي يحملها.
فالخليفة لا يحمل في قلبه حقدًا على مؤمن، ولا غلًّا على عبدٍ قال “لا إله إلا الله”، بل قلبه بابٌ مفتوح، ونفسه سِراجُ محبة، وعينُه تبصر الخلق بعين المودّة، ويُعامل عباد الله كما عاملهم نبيُّ الله: باللين، والحِلم، والصفح، والدعاء، والرّفق في التعليم، والتلطف في التربية.
وقد قال ﷺ:
“اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون.”
قالها في لحظة أُذِيَ فيها، لأن قلبه ما عرف الحقد، بل كان حُبًّا محضًا، ورحمةً مطلقة.
فالعارف لا يرى في الأكوان إلا مرآة الرحمة، لأنه أخذ عن الخليفة الأعظم، الذي ما نزل إلا رحمة.
فالخليفة الكامل مَن تشعّ الرحمة من قلبه إلى داره، ومن داره إلى حيّه، ومن حيّه إلى أمّته، بل إلى الطير في السماء، والحيتان في البحر، والأشجار في البراري، لأنه عبدٌ لله، قام بأمر الله، وسار على سُنّة رسول الله.
قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: 107] بل إنَّ رسول الله ﷺ حذَّر من ظلم الحيوان، كما في الصحيح:
“دخلت امرأة النارَ في هِرّة، حبستها، فلا هي أطعمتها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض.”
6- قال تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ [القلم: 4] هذه الآية وحدها تكفي للدلالة على صفات الخليفة، فالله جل جلاله لم يصف نبيَّه ﷺ بالعلم – مع عظيم علمه – ولا بالعبادة – مع سموّ مقامه – ولا بالعدل، ولا بالزهد، بل اختار أن يختِم شهادة السماء بهذه الكلمة الجامعة: “خُلُقٍ عَظِيمٍ”.
وجه الدلالة:
أنَّ هذا الخُلق العظيم ليس صفةً عرضية، بل هو أساس الخلافة النبوية، كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها:
“كان خلقه القرآن.” [رواه مسلم].
فمن أراد أن يتحقّق بمقام الخلافة، فليجعل القرآن معلّمه، والسنّة إمامه، والنبيَّ ﷺ قدوته، حتى يُبصر الخلقُ في سُلوكِه نورَ الوحي، وفي سكينته روحَ الرحمة، وفي معاملته ميزانَ العدل، وفي كلامه حِكمةَ الرسالة.
فطريقنا هذا كلُّه أدبٌ مع الله، ثم مع الخلق، ومفتاحُه الاقتداءُ برسول الله.”
فالخليفة الكامل هو مَن إذا سكت، سَكَت بأدب القرآن، وإذا نطق، نطق بحِكمة السنّة، وإذا غضب، لم يتجاوز حدّ العدل، وإذا رضي، لم ينسَ حدودَ الحق، فهو عبدٌ لله في أحواله، نبيٌّ في أخلاقه، خليفةٌ في مقامه.
فأكملُ الناس خِلافةً: مَن صار خُلُقُه كخُلُق نبيِّه، وسيرتُه كسيرته، وفعلُه دالًّا على المرسِل.
7- أن يكون داعيا الى من استخلفه: ﴿وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا﴾ [الأحزاب: 46]. ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾ [آل عمران: 159] فالخليفة في الأرض ليس منصبه زينة، ولا مقامه شرفًا دنيويًّا، بل هو داعٍ إلى مَن استخلفه، ومبلّغٌ عنه، وهادٍ إلى سبيله، فهو لا يدعو إلى نفسه، ولا إلى جاهه، وإنما يدعو إلى ربّه؛ ساجدًا في محراب العبودية، وواقفًا على باب المحبة، ومناديًا الخلق إلى نور ربّهم.
أنَّ الخلافة ليست منصبًا قياديًّا فقط، بل هي منصب دعويٌّ في جوهره، لأن الخليفة نائبٌ عن الحقّ في أرضه، ودعوتهُ إلى الله هي شرطُ صحّةِ خلافته، فإن لم يدعُ إلى الله تعالى، فليس خليفة، بل مدّعٍ، لأن مقام الخلافة قائم على النيابة، والنيابة لا تتمّ إلا بالتبليغ.
وقد وصف الله نبيَّه ﷺ بأنه داعٍ إلى الله بإذنه، وسراجًا منيرًا، فجمع بين الدعوة والنور، وبين الإذن والرّسالة، فمن أراد أن يسير على أثر النبيّ في خلافته، فليكن داعيًا لا داعية، مناديًا لا متصدرًا، هاديًا لا مستعليًا، سراجًا لا سيفًا، رحمةً لا نقمة.
فالخليفة لا يُطاع لنفسه، بل يُطاع لأنه يدعو إلى الله تعالى، فإذا دعا إلى غيره، سقطت عنه النيابة.
والآية الثانية توضّح أسلوب الخليفة في الدعوة: بلين الجانب، ورفق القلب، وعفوٍ يتقدّمه الاستغفار، ومشاورةٍ تهدي إلى الصواب، فإن الدعوة لا تُثمر ما لم تزرع في تربةِ الرحمة، وتسقَ من ماء التواضع، وتُشرِق بشمس الحِلم.
“فالداعيةُ الذي يفتح القلوب، أقربُ إلى الله من الذي يطرقها بالسيوف.”.

الخلاصة عن مفهوم الخلافة ومستلزماتها
نُجدد محبتنا لرسول الله (صلى الله عليه وسلم), لمعرفة المزيد من المقالات حول السيرة النبوية وقضايا التزكية والأخلاق، يمكنك زيارة موقع الشيخ خلدون.